الرئيسية
| شجرة الموقع
| إحصائيات
| قائمة الأعضاء
| سجل الزوار
|إنشاء حساب
| اتصل بنا

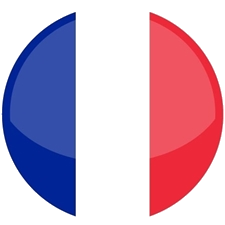

|

|
Loading...
|
جديد الموقع:
|

|
أبواب الموقعقائمة المراسلةحالة الطقسحكمة
الصديق وقت الضيق
تحويل التاريخحدث في مثل هذا اليومصحة جسمكمواقع صديقة |
 الوكالة العربية للصحافة أپاپريس - Apapress الوكالة العربية للصحافة أپاپريس - Apapress
 مقالات مقالات
 أفكار و تحاليل أفكار و تحاليل  يعود، لا يعود! يعود، لا يعود!
 الثنائية الدموية التي تفرق المصريين منذ أن أسقطوا رئيسهم الإخواني الذي كان أول من انتخبوه لأعلى منصب في جمهوريتهم - ربما لأنه لم يكن لهم اختيار آخر وقتئذ أو لأنهم اقتنعوا بخطاب الإخوانين الذين قدموا نفسهم بأن أيديهم نقية وبأنهم سينقذون البلد مما هو فيه أو لأن خلطهم الخطاب السياسي بالديني نتج عنه خلط في أذهان الناس بين ما هو مقدس وإلاهي وما هو إنسي غير معصوم يحتمل الخطء والذنب. تفرق هذه الثنائية أيضاً بين دول الخليج ودول الجوار وباقي دول العالم، ليس بنفس الدموية طبعاً ولا بنفس الحدة التي يتواجهون بها في سوريا إلى حد الآن على الأقل.
الثنائية الدموية التي تفرق المصريين منذ أن أسقطوا رئيسهم الإخواني الذي كان أول من انتخبوه لأعلى منصب في جمهوريتهم - ربما لأنه لم يكن لهم اختيار آخر وقتئذ أو لأنهم اقتنعوا بخطاب الإخوانين الذين قدموا نفسهم بأن أيديهم نقية وبأنهم سينقذون البلد مما هو فيه أو لأن خلطهم الخطاب السياسي بالديني نتج عنه خلط في أذهان الناس بين ما هو مقدس وإلاهي وما هو إنسي غير معصوم يحتمل الخطء والذنب. تفرق هذه الثنائية أيضاً بين دول الخليج ودول الجوار وباقي دول العالم، ليس بنفس الدموية طبعاً ولا بنفس الحدة التي يتواجهون بها في سوريا إلى حد الآن على الأقل.فبين سيعود وسنعيده على الأكتاف ولن نفض الاعتصام إلى أن يعود وسنضرمها ناراً إلى أن يعود وبين قد سقط وذهب ريحه إلى الأبد ولم يعد له دور وقد طوينا صفحته ولن نتنازل ولن نقبل بعودته ولا بعودة نظامه، تفور الدماء ويفقد الرشد وتطلق النيران ويموت مصريون. بين خليجيين مناصرين لفريق الرئيس المعزول وخليجيين آخريين فرحوا لذهابه وأسرعوا للإعلان على دعمهم النظام الجديد بآضعاف أضعاف ما كانت تنوي أكبر دول العالم بالضغط به عليه ومقابل ما كان الآخرون يدعمون به الرئيس المخلوع وكأنهم يقولون للنظام الجديد تقدم ولا عليك. وبين تغطية الجزيرة القطرية قبل وبعد استقالة العشرات من صحفييها احتجاجاً على عدم مهنيتها وعدم موضوعيتها وافتضاح أمرها عالمياً كما تشهد على ذلك المقالات المدهوشة في كبار صحف أمريكا التي كانت تكن لها التقدير والدعم وبين تغطية العربية التي اكتشف من كان لا يعرف أنها ذراع السعودية أكبر دول الخليج في صراعها الإيديولوجي المرير وعلى الهيمنة مع الجزيرة وأصغر دويلات الخليج وأقلها سكاناً وبين القنواة المصرية التي لم يغلقها الجيش تضيع الدقة في المعلومة والموضوعية وتتحول القنوات والصحافة إلى أجهزة لإضفاء المشروعية أو لحجبها وإلى الحشد وتهيج النفوس وتعطيل العقول والدفع إلى العنف والإرهاب وإلى الحكم والتجريم صراحة والتكفير ضمنياً لما تستدعي لبرامجها من يفعلون وتقدمهم كأبطال وضحايا تآلب العالم كله ضدهم ولما تستعمل مواقع صحفييها الشخصية لبث الحقد والتهيج خروجاً على أخلاق المهنة! كما أن نفس الثنائية تسِم مواقف الحكومات العربية وغيرها مما حدث في مصر. فالحكومات ذات الطبيعية السياسية الإسلامية والتي تستمد رؤيتها وشخصيتها من إيديولوجية الإخوان المسلمين تعبر على معارضتها لما حصل - لما تقدر ولا يعارض ذلك مصلحتها السياسية مباشرة - وتعتبره خروجاً على المشروعية. كما تغرق هذه الثنائية دول أخرى، كتركيا في الحرج والارتباك وهي التي تواجه ما يشابه ما سقط به الرئيس المصري والتي على ما يروج قد تكون تتحد مع إسرائيل ضد شعوب عربية ومسلمة في هذه الظروف القاسية. أما الحكومات التي لم تفتئ جماعات قريبة من الإخوان المصريين أو من بناتها أن تحاول التضييق عليها وهز استقرارها فقد سارعت لتأييد ومباركة الحركة التي أودت بها. أما الغرب فجهله المزمن والمطبق لأسرار السياسة والإيديولوجيات والثقافات العربية الإسلامية فلم تكن مواقفه مختلفة عما ألفه الناس منه فهي متدبدبة غامضة مترددة متقلبة. فمع ما يصرفه الغرب من أموال طائلة لفهم هذه المنطقة وتوقع تطوراتها وصنع قرارات تحمي مصالحه فيها لم يستطع أن يفعل وبقى رهيناً بالتدخل في أشد الأوقات حرجاً وبوسائل وطرق لا تزيد شعوب المنطقة إلا فقدان الثقة فيه وابتعاداً منه. فالتصريحات الغربية الرسمية وشبه الرسمية تضر مصالح الغرب أكثر مما تنفعها وكأنه يستعصي عليه أن يعترف بأن عرب ومسلمي القرن الواحد والعشرين ليسوا نفسهم الذين استعمرهم في القرون الماضية وبأن لهم الحق في أن يتطلعوا للاستقلال برأيهم في أمورهم وأن يختاروا من يصادقون وأن لا يصادقوا من عاداهم. فكلما تحدث رئيس دولة غربية أو ناطق رسمي باسمها أو أسرع وزير لخارجيتها أو مساعد له لملاقاة قيادة عربية جديدة إلا واعتبر أنه من الضروري أن يؤكد على أن هدفه ليس أن يفتي عليهم ما يفعلون وأنه يحترم اختياراتهم - نتساءل ما الذي يضطرهم لمثل هذا الاحتياط إن يكن ضرر في نفوسهم. إلا أن هذه الأقوال تناقض أفعالهم والقرارات التي يتخذونها إذ لا يترددون في فرض الشروط وإعطاء الآجال وفي الاجتماع مع النقابات والأحزاب والجيش والحركات الثورية علماً أنهم لا يقبلون أن يقوم بمثل هذا أجنبي في بلدانهم وأنهم يسمونه التدخل في الشؤون الداخلية. فيمكن تصور ماذا سيحث لو انتقل إلى أوربا، مثلا، وزير خارجية دولة عربية وعقد اجتماعات مع المعارضين الباسك أو الكرسيكين ومجموعات مسلحة أو إرهابية ورجال الكنائس ثم صرح بأن على أوربا أن تستمع لهؤلاء وأن تشركهم في حكوماته وإلا عاقبتهم دولته وفرضت عليهم حذراً اقتصادياً، الخ.. التحديات التي تواجهها الحكومة المصرية الانتقالية متجدرة في هذه الثنائية خصوصاً وأنها عجزت أن تقنع الإخوان وحلفاءهم أن يلتحقوا بها. فكيف سيتسنى لها أن تتغلب على المعضلات الاقتصادية والحركة شبه متوقفة في البلاد وأهم شوارع العاصمة مشلولة والأمن مهدد بالسلاح في أيد لا تتورع ولا تتردد في استعماله ضد العمال المدنيين والجيش وهل من عدالة اجتماعية دون الأمن الاجتماعي والاستقرار السياسي والاقتصاد متوقف. وكيف ستتمكن الحكومة الانتقالية من إخراج دستور جديد مقنع لكل المصريين ومتوافق عليه وعنصر مهم من المجتمع لم يشارك في إنتاجه وكيف ستنظم استحقاقات الدمقراطية من استفتاء على الدستور وانتخابات ممثلي الشعب والرئيس والحالة غير آمنة وغير مستقرة والتصعيد في أوجه والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وإرجاع المعزول لكرسيه في أشده؟ إلا أن تكون للحكومة الانتقالية قوة خارقة ستتمكن بها من التصالح مع مخاصميها أو حججاً دامغة وخطاباً ذا قوة خارقة له من السلطة الفكرية ما يضحد به الخطاب الديني الذي يغلف فيه الإخوان دوافعهم السياسية والحوافز التي يحركون بها الناس والدوافع التي يهيجونهم بها ويعللون بها حثهم على ما يفعلون، فستكون الحكومة مطالبة برفع إكراهات الحياة اليومية على الناس وأن توفر لهم ظروفاً عامة يسترجعون فيها الأمل والثقة والإحساس بالكرامة والحرية الذين هم في أكثر حاجة لهم من الخبز والغاز والمحروقات والكهرباء. تعليقات القراء
|
أكثر المقالات تعليقاًأخبارنا بالقسم الفرنسيأخبارنا بالقسم الانجليزيكريم عبدالرحيم التونسي المعروف بعبد الرؤوففوزالباحث المغربي عدنان الرمال بالجائزة الكبرى للابتكار من أجل إفريقيا لسنة 2015الإعلانات الجانبيةصور عشوائيةفيديوهات عشوائيةلعبة |
 إحصائيات: إحصائيات:يتصفح الموقع الآن 7 شخص، 0 عضو، 7 زائر (انقر هنا لمزيد من التفاصيل عن حركة الزوار)، عدد محتويات الموقع: 2317 |
جميع الحقوق محفوظة لـ الوكالة العربية للصحافة أپاپريس - Apapress .
تغيير السمة: بالاعتماد على برنامج بوابة الجوزاء |
للنشر في الموقع | شروط الإستخدام | للتواصل مع الموقع | نهج الخصوصية | الإدارة | أعلن معنا | فريق العمل | المتعاونون | شعار أبابريس |










.jpg)


.jpg)
.jpg)




