الرئيسية
| شجرة الموقع
| إحصائيات
| قائمة الأعضاء
| سجل الزوار
|إنشاء حساب
| اتصل بنا

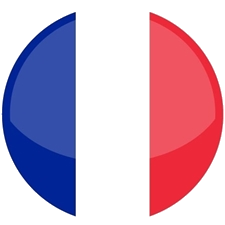

|

|
Loading...
|
جديد الموقع:
|

|
أبواب الموقعقائمة المراسلةحالة الطقسحكمة
السكوت علامة الرضا
تحويل التاريخحدث في مثل هذا اليومصحة جسمكمواقع صديقة |
 الوكالة العربية للصحافة أپاپريس - Apapress الوكالة العربية للصحافة أپاپريس - Apapress
 مقالات مقالات
 أدب وفنون أدب وفنون  درويش: التوراتيات سياسية بامتياز! درويش: التوراتيات سياسية بامتياز!

تعتبر الرموز والإشارات المُشفرّة التي يستخدمها الفرد والجماعة مفاتيح للبحث في المستويات الواعية واللاواعية في الهوية الفرديّة والجمعية على حدّ سواء. لذا باتت دراسة مكنونات وإشارات هذه الرموز تشكل حقلاً معرفيّاً بالغ الأهميّة للتعرف على مركبات ومستويات هذه الهوية، ابتداءً من السياسة ومروراً بعلم الإنسان ووصولاً إلى علم النفس، من أجل التنكيل بها أو استنهاضها أو التكيّف معها على حدّ سواء.
تزخر النصوص الأدبية النثرية والشعرية بهذه الرموز والإشارات، لأن الأدب شأنه شأن بقية الحقول المعرفية والجمالية الأخرى تراكميّ يبني على ما سبقه، ويؤسس لما سيخلفه. وبما أن الأدب ليس السياسة الممارسة المكشوفة، وإن عبّر عنها، فإنه كثيراً ما يلجأ لاستخدام هذه الرموز، للإعلان عن موقف سياسي واجتماعي، مثله مثل الفكري والجمالي والفلسفي بطريقة غير مباشرة. وعليه فإن الإدعاء إن استحضار الأدب لهذه الرموز والإشارات يقع في مجال التناص الأدبي فقط، محض تضليل.
نشر الأستاذ سامي مهدي مقالاً في ملحق شرفات ثقافية في الحادي والعشرين من شهر أيلول الجاري بعنوان: محمود درويش والتوراة، فيه رد وسجال مع مقال يحمل نفس العنوان والموضوع للزميل موسى حوامدة، محرر الملحق المذكور. في مقاله المنشور في شرفات ثقافية في نيسان الماضي، يطرح الزميل حوامدة سؤالاً هاماً حول كثرة استخدام محمود درويش (1941- 2008) لاستعارات وإشارات من التوراة، كتاب اليهود المقدس، ألا وهو: هل وقع درويش تحت تأثير وسطوة التوراة والشعر العبري؟ وقد ردّ الأستاذ سامي مهدي في مقاله بالنفيّ وبالتأكيد على أن الإشارات والاقتباسات من التوراة ليست إلا تناصاً أدبياً يشيع حضوره في الشعر العربي والأجنبي أيضاً. وبما أني كنت أول من تطرّق إلى الرموز التوراتية وأبعادها السياسية في كتابي: التوراتيات في شعر محمود درويش (من المقاومة إلى التسوية) الصادر عن دار قدمس في الشام عام 2005؛ حيث شرحت أن درويش شاعر- سياسي ويحسب إشاراته واستعاراته الأدبية للتدليل على موقفه التسووي القاضي بالتنازل عن أربعة أخماس وطننا للمستعمرين الصهاينة. وقد رأيت، في هذا المقال، وجوب دعوة محمود درويش لتقديم مداخلة مكونة من خمس إشارات من كتاباته الشعرية والنثرية وممارسته السياسية، بما يجيب على نقاش حوامدة ومهدي، والطرفين اللذين يعبّران عنهما، ويؤكد على ما قدمته في كتابي بأن درويش شاعر- سياسي بامتياز، وأظنني لا أبالغ إن قلت أنه كثيراً ما كان يتكئ على الأدب للتعبير عن السياسي.
الإشارة الأولى- كان درويش قد أجاب على سؤال في حوار أجرته معه مجلة الكرمل عام 1995 عن كثرة استخدامه الرموز التوراتية بالقول: “ليس استعمال مثل هذه الإشارات [الرموز التوراتية] لدواع جرسية وتغريبية فقط. إنها موظفة- إذا جاز التعبير- لإخراج الراهن ووضعه في أيقونة أو دراما تاريخية. أي لجعل النصّ يعمل في التاريخ أو الماضي. يعمل في اللحظة نفسها على مستويين زمنيين مختلفين”. أي أن الأمر لا علاقة له بالتناص الأدبي المجرد كما يدعي الأستاذ مهدي.
الإشارة الثانية- كان محمود درويش قد ألقى كلمة في جنازة إميل حبيبي (1921- 1996) في الناصرة. وقال فيها مخاطباً حبيبي بـ”معلمي”: “لقد شاءت طبيعة التطور التاريخي في تقاطع المصائر الإنسانية أن تجعل هذه الأرض المقدسة بلداً لشعبين [...] وكنت أنت منذ البداية وحتى هذه اللحظة، أحد المنابر المتحركة الأقوى والأعلى، الداعية إلى سلام الشعوب بحق الشعوب. السلام القائم على العدل والمساواة ونفي احتكار الله والأرض، للوصول إلى المصالحة التاريخية بين الشعبين، مع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس [...] إذا كنا نلعب، فتلك هي شروط اللعبة، لساناً بلسان، لا طائرة ضد طائر. وفي هذه المنطقة أيضا يتبطن المعنى ثانياً، ويلجأ إلى ذاته ساخراً من عبء رسالتها فيخفّ الحمل الثقيل من أجل الانتقال إلى حمل أثقل، في صحراء الإيقاع الذي لا يتوتر إلا لينسجم السياسي مع الأدبي”. وبما أن “هذه الأرض المقدسة بلداً للشعبين”- كما يؤكد- فإنه بحاجة إلى الإشارات والرموز المقدسة كي تسهم “في المصالحة التاريخية بين الشعبين”. وبما أن التوراتيات مشتركة “للشعبين” توجب استخدامها كي يقنعهما بتقاسم الأرض والركون “إلى المصالحة التاريخية” بينهما. وهذا يدفعنا للتساؤل: أليس توظيف هذه الرموز سياسياً!؟
وعندما نأتي على ذكر إميل حبيبي، لا بدّ من التأكيد على أن إميل حبيبي كان ضمن وفد الحزب الشيوعي الإسرائيلي الذي ضمّ إضافه له موشي سنيه (1909- 1972) وشموئيل ميكونيس (1903- 1982)، إلى تشيكوسلوفيا قبل قيام الكيان الصهيوني في العام 1948 للتباحث مع قيادتها، وهناك أقنعوا التشيك بأن تكون أول دولة ترسل السلاح للعصابات الصهيونية! وقد كرّمته دولة إسرائيل بأن منحته “جائزة إسرائيل بالأدب” عام 1996. وكذلك أطلقت بلدية حيفا الصهيونية اسمه على شارع في وادي النسناس في حيفا. وللمفارقة: إذا كان درويش قد وصف حبيبي بـ”معلمي” فإن الشاعر والسياسي توفيق زياد (1929- 1994)، رفيق وزميل وصديق درويش لعقود طويلة، وصف حبيبي بالمرتد ورماه بقصيدة يقول فيها:
“يهرب المرتد من كل المبادئ
ويسمي قفصاً كل التزام بالحقيقة
ويسمي الردة النكراءَ
عتقا وانفتاحا
يهرب المرتد.. نحو الغاب،
نحو القسمة الضيزي وحكم السيد المالك
حكم الغاصبين
حَرَفته شرعة الغاب إليها
علّه يصبح ذئبا (أو ذؤيبا)
ذات يوم
عائدا نحو القديم العفن البالي
وأصل النكبات
عائدا يطلب “حقّا”
حصّة المرتضى عنه،
من فتات المائدة”.
الإشارة الثالثة- في العام 2002 شارك درويش في مهرجان الشعر العالمي في برلين عام 2002. وفي مقابلة مع “إلداد بيك” قال مراسل صحيفة “يديعوت أحرونوت” الـ”إسرائيلية” ما يلي: “[...] ولكن موضوع القصيدة- مقاومة أو احتجاجاً- لا يهمّني، وما يهمّني هو الجوانب الجمالية”. أما في الأمسية الشعرية “جامعيون من أجل فلسطين” التي نظمتها الجامعة الأمريكية في القاهرة في شهر كانون الأول من العام 2003، فقد قال درويش قولاً مختلفا للغاية: “الشاعر في مرحلة الطوارئ سياسي بالضرورة لأنه جزء من مقاومة الاحتلال وهو مطالب بالوفاء للصورة التي يرسمها له القارئ ومطالب أيضاً بالتمرد على ما هو متوقع منه”. بناء على الإشارتين الأولى والثانية نريد أن نصدق ما قاله درويش في الجامعة الأمريكية في القاهرة، أي أنه شاعر سياسي بامتياز، وما استخدامه للرموز التوراتية إلا بغرض سياسي.
الإشارة الرابعة- بعد عدة أشهر من احتلال العراق عام 2003 عقد رأسماليو العالم منتداهم الدوري الاقتصادي “دافوس” في أحد منتجعات الجانب الأردني من البحر الميت. حضر المنتدى “بول بريمر” القائد العسكري للعراق المحتل في حينه والصهيوني “شمعون بيرس” إضافة إلى 140 شخصية سياسية- اقتصادية أخرى، وكذلك الشاعر- السياسي محمود درويش. وفي المؤتمر، ألقى درويش قصائد لمدة ثماني دقائق! “بريمر” و”بيرس” وغيرهم ليسوا مثقفين ليمضي درويش معهم أمسية ثقافية، إنهم سلاطين المال وإفقار الشعوب. في هذا السياق، قبل درويش على نفسه ليس فقط تجنيد الثقافة في خدمة أهداف مؤتمر “دافوس”، بل إنه ولمكانته الرفيعة في حقل الثقافة، أضفى مشروعية أخلاقية على مخططات مؤتمر “دافوس” واحتلال العراق. ولو بقي على التوراتيات فقط لحمدنا ربّنا وشكرناه!
الإشارة الخامسة- إضافة للتوراتيات استخدم درويش الرموز والإشارات الكنعانية. في قصيدته “على حجر كنعاني في البحر الميت”، يقول فيها مخاطباً العدو الذي أصبح “الـ”غريب”:
“علّق سلاحك فوق نخلتنا يا غريب، لأزرع حنطتي
في حقل كنعان المقدس.. خذ نبيذًا من جراري
... وقسطًا من طعامي
... خذ
صلوات كنعانية في عيد كرمتها...”
ليضيف: “فيا غريب...
أوقف حصانك تحت نخلتنا! على طريق الشام
يتبادل الغرباء في ما بينهم سينبت فوقها
حبق يوزعه على الدنيا حمام قد يهبّ من البيوت”.
ويضيف في ديوانه “لماذا تركت الحصان وحيدا؟” مخاطبا العدو الذي أصبح “غريب” قائلا:
“سّلِّم على بيتنا يا غريب
فناجين قهوتنا لا تزال على حالها
هل تَشُمُّ أصابعنا فوقها؟
هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكثيفين إنَّ لها صاحبًا غائباً”
و:
“... لن تنتهي الحرب ما دامت الأرض
فينا تدور على نفسها!
فلنكن طيبين إذاً. كان يسألنا
أن نكون طيبينَ. ويقرأ شعرًا
لطيار “ييتْس”: أنا لا أحب الذين
أدافع عنهم، كما أني لا أعادي الذين أحاربهم...”.
و كي يقنع الفلسطيني بأن لا طائل أو فائدة من نضاله يقول:
“[...]: وهل كان ذاك الشقي
أبي، كي يحمّلني عبءَ تاريخه؟”.
و:
“الشعر سلّمنا إلى قمر تعلقه أنات [عنات]
على حديقتها، كامرأة لعشاق بلا أمل،
[...]
وأنات تقتل نفسها
في نفسها
ولنفسها”.
المثير حقّاً عند درويش أن عنات جدتنا الكنعانية هي التي تقتل نفسها/ في نفسها/ ولنفسها، أما أبطال التوراة فقد ظلوا أحياء وأبطالا، لذا علينا تقاسم وطننا مع أحفادهم المستعمرين! والقول إن التناص عند درويش لأغراض فنيّة فقط، مردود على الذي يدعيه، لأن درويش نفسه قال عكسه. وكنت قد عرضت هذا وشرحته في كتابي “التوراتيات في شعر محمود درويش
تعليقات القراء
|
أكثر المقالات تعليقاًأخبارنا بالقسم الفرنسيأخبارنا بالقسم الانجليزيكريم عبدالرحيم التونسي المعروف بعبد الرؤوففوزالباحث المغربي عدنان الرمال بالجائزة الكبرى للابتكار من أجل إفريقيا لسنة 2015الإعلانات الجانبيةصور عشوائيةفيديوهات عشوائيةلعبة |
 إحصائيات: إحصائيات:يتصفح الموقع الآن 26 شخص، 0 عضو، 26 زائر (انقر هنا لمزيد من التفاصيل عن حركة الزوار)، عدد محتويات الموقع: 2317 |
جميع الحقوق محفوظة لـ الوكالة العربية للصحافة أپاپريس - Apapress .
تغيير السمة: بالاعتماد على برنامج بوابة الجوزاء |
للنشر في الموقع | شروط الإستخدام | للتواصل مع الموقع | نهج الخصوصية | الإدارة | أعلن معنا | فريق العمل | المتعاونون | شعار أبابريس |











.jpg)

.jpg)
.jpg)




