الرئيسية
| شجرة الموقع
| إحصائيات
| قائمة الأعضاء
| سجل الزوار
|إنشاء حساب
| اتصل بنا

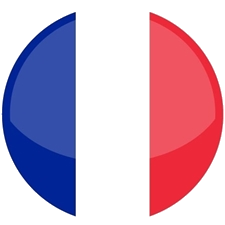

|

|
Loading...
|
جديد الموقع:
|

|
أبواب الموقعقائمة المراسلةحالة الطقسحكمة
الباب يلي يجيك منه الريح سده و استريح
تحويل التاريخحدث في مثل هذا اليومصحة جسمكمواقع صديقة |
 الوكالة العربية للصحافة أپاپريس - Apapress الوكالة العربية للصحافة أپاپريس - Apapress
 مقالات مقالات
 أدب وفنون أدب وفنون  متعة الكتابة الروائية أو حينما يعيش المرء حياة مضاعفة متعة الكتابة الروائية أو حينما يعيش المرء حياة مضاعفة
الكتابة أعمق من ذلك بكثير..إنها ورطة جميلة ، تلقي بشباكها على الكاتب ،و تأسره بخيوطها المخملية الرفيعة و المتينة ، فلا يملك إزاءها حلا غير الاستسلام التام ، فكلما حاول الفكاك منها، زادت تعلقا به في نوع من الزواج الكتوليكي.. حينذاك تصبح الكتابة أسلوب حياة ، يتنفسه الكاتب ، و على إيقاعه المتعرج تمضي حياته ، مأسورا يقدم لها نفسه و فكره و أعصابه قربانا يوميا .. أما الجائزة الكبرى التي ينالها فتتمثل في أنها قليلا ما تخونه ، إنها وفية بقدر ما يمنحها من قلبه ، مع أنها غيورة إلى حد التملك ، أتذكر في هذا الصدد ذلك التعبير الجميل لطوماس وولف حينما شبه الكتابة بالدودة فيقول " لقد نفذت الدودة إلى قلبي و هي منطوية على نفسها تتغذى من مخي وعقلي و ذاكرتي" و أقول إنها دودة أسطورية لا تتوقف عن التضخم ، حتى تحتل الجسد بأكمله ، و هي لا تكف عن الازدراد بشهية مفتوحة ، و على الكاتب أن يوفر لها غذاءها ، و الغذاء هنا هو تجربة الكاتب الحياتية و قراءاته ، هذان المكونان هما الوقود الذي يحرك آلة الكتابة و بالطبع فالخيال يتوجهما.. الكتابة بدون تجربة عميقة في الحياة تغدو ضحلة سطحية و لا روح فيها .. أومن بأن الكاتب إن انطلق مما عاشه و يعيشه و خبره ، بل ما رجه رجا عنيفا ، ضمن لنفسه أسباب النجاح ..أما إذا اعتمد على الذاكرة فسرعان ما يجد طريقه نحو الإفلاس ، و سيكرر ذاته في أحسن الأحوال أويستنسخ كتابات الآخرين ، في حين إذا اعتمد على تجاربه الخاصة، فإنه بالضرورة سيكون مختلفا ، لأن كل تجربة حياتية فريدة من نوعها و لا تتكرر أبدا إذ "لا نستحم في نفس النهر مرتين" ..طبعا لا يمكن استنساخ التجارب أو نقلها حرفيا بل يتعين أن تشكل الأرضية الصلبة التي ينطلق منها الكاتب ، ثم يأتي دور الخيال الذي هو – بلا جدال – رأسمال الكاتب إن فقده ، فقدت كتابته مبرر وجودها. تمثل القراءة الوجه الثاني لعملة الكتابة ، إنها الزاد الذي تتغذى عليه الدودة المستقرة في مخ الكاتب .. القراءة متعة و وسيلة مثلى للتعلم و للتلاقح و لمحاورة إبداعات و أفكار المبدعين .. كل كتاب أقرؤه بمثابة رحلة اكتشاف جديدة و مائدة دسمة ، تفتح لي دروبا جديدة في عالم الكتابة ، و لا تكون القراءة مفيدة و ذات معنى إن لم أكتب عن الكتاب الذي قرأته ، و لا يتأتى ذلك إلا بعد قراءته مرات عدة ، القراءة الأولى استكشافية و الثانية تأملية و الثالثة حوارية و الرابعة للقبض على ما سكت عن ذكره الكاتب و هكذا دواليك .. كل قراءة جديدة لكتاب ما تكسبني خبرة جديدة. الكتابة حياة مضاعفة. كيف ذلك ؟ إنها تفتح للكاتب المجال للعيش حياة أخرى بل حيوات مفترضة ، أجدني أقول " ما أضيق العيش لولا فسحة الخيال" ..بالخيال يحيى الكاتب ، يبني عوالم ثم يهدمها ليبني غيرها ، يحرك شخوصه في فضاءات من ابتكاره ، يضع شيئا منه في كل شخصية من شخوصه ، و كأنه يوزع دمه ما بين القبائل. ، إنها لعبته الأثيرة. ما كتبته لحد الآن من روايات يتيح لي أن أقول مطمئنا بأن وراء جلها تجارب حيايتية قوية ، عشتها في حينها بكل جوارحي ، و بعد مرور قدر من الزمن كاف لاختمار التجربة، استثمرتها في الكتابة ، فقط أتمنى أن أكون وفقت في ذلك. في رواية رجال و كلاب ،و هي الأولى نشرا و ليس كتابة ،اعتمدت من حيث التكنيك على التداعيات الحرة كتقنية مقتبسة من التحليل النفسي ، لأن ثيمة الرواية فرضت علي ذلك ، ف "علال" الشخصية الرئيسية مصاب بمرض الوسواس القهري ، فاختار أن يجعل من القارئ طبيبه النفسي ، لذا كان لزاما عليه أن يفتح قلبه للقارئ ، و يخاطبه مباشرة ليبوح له بما و قر في النفس من ذكريات ، متوسما في ذلك تخلصه من المرض الذي لازمه مدة طويلة و لا يعرف له سببا.. ملهما في ذلك بفكرة التحليل النفسي اللامعة و التي مفادها أن المرض يخف و يضمحل بعد أن تتحول أسبابه إلى كلمات. في رواية "عائشة القديسة" استثمرت مكانا كنت و لا أزال أمارس فيه مهنة التدريس ،على مرمى بصر من المحيط الأطلسي ، هناك حيث تشيع بين الناس أسطورة "عيشة قنديشة" ، فوظفت هذه الأسطورة لكتابة رواية تراهن على التنوير و التطهير بمعنى" الكتارسيس" من خلال جعل القارئ يقف وجها لوجه أمام هذه "الجنية" الجميلة ، التي شغلت بال الناس و سارت بذكرها الركبان. أما رواية "أحلام النوارس" فكنت محكوما فيها بإرجاع بعض الدين لفئة من الناس دفعت ضريبة كبرى من شبابها و صحتها و حياتها أحيانا ، من أجل أن أنعم بهذه الحرية النسبية التي تتيح لي الكتابة دون رقيب خارجي ، أقصد شبابا ناضلوا و أمسكوا بالجمر ملتهبا فدفعوا الثمن سجنا و تعذيبا و عاهات ، من أجل أن تتحقق لغيرهم حياة أفضل ، كتبت هذه الرواية على شكل رسالة مطولة بعث بها مناضل و سجين رأي سابق إلى حبيبته ، التي تخلت عنه كما تخلى عنه الجميع ، فانزوى في غرفة قصية منعزلة هي امتداد لزنزانته ، التي حملها معه في دواخله ،ليكتب رسالته الأخيرة. في رواية "ليلة إفريقية" كنت محكوما بتكنيك الكتابة ، فوظفت تقنية رواية داخل رواية ، أو ما يصطلح عليه ب بتقنية "دمى البابوشكا الروسية" ، كما استثمرت تقنية الميتارواية ، بما يعني أن الرواية تفكر في ذاتها بصوت مسموع ، و هي تنكتب أمام أعين القارئ، كما شغلني من حيث الثيمات التعدد الثقافي للمغرب ، ممثلا في البعد الإفريقي الذي يبدو مغيبا بسبق إصرار و ترصد ، دون أن تعزب عن الذهن هموم الكتاب و حياتهم السرية و علاقاتهم ، خاصة فيما يخص صراع الأجيال. في رواية " رقصة العنكبوت" هيمنت على تفكيري مشاكل الشباب العاطل ، فحاولت طرحها من خلال الشخصية الرئيسية "يوسف" الفنان الشاب ، الذي لم يغن عنه فنه فتيلا ، فسقط لقمة سائغة في فم البرجوازية المتعفنة ، ممثلة في تاجر لوحات شاذ جنسيا ، يستعمل الفن طعما لإشباع نزواته الشاذة ، أما على مستوى التكنيك فوظفت فيها أسلوب كتابة القصة القصيرة. في رواية ابن السماء حاولت تتبع تشكل العقلية الخرافية لدى الإنسان المغربي خصوصا و العربي عموما من خلال شخصية عجائبية فرت من نعيم السماء إلى جحيم الأرض محاولة إصلاحه لكنه كان لها بالمرصاد ، فاستغلها اهل الدنيا أسوأ استغلال من أجل تحقيق مكاسب دنيوية محضة ، أما في رواية "على ضفاف البحيرة" فشغلتني الطبيعة الجملية لجبال الأطلس و أناسها ،فكتبت رواية تحتفي بهذين البعدين العميقين و المميزين للمنطقة ، كما تناولت في رواية "أسلاك شائكة " التي اقتبست أحداثها لتكون فيلما قد يرى النور قريبا ، مشكل الحدود المغلقة ما بين المغرب و الجزائر و تأثيراته الكارثية على الإنسان في البلدين. شكرا لكم صديقاتي أصدقائي .. شكرا لكم زملائي المبدعين .. و معا نخلق مجد الأدب المغربي المعاصر تعليقات القراء
|
أكثر المقالات تعليقاًأخبارنا بالقسم الفرنسيأخبارنا بالقسم الانجليزيكريم عبدالرحيم التونسي المعروف بعبد الرؤوففوزالباحث المغربي عدنان الرمال بالجائزة الكبرى للابتكار من أجل إفريقيا لسنة 2015الإعلانات الجانبيةصور عشوائيةفيديوهات عشوائيةلعبة |
 إحصائيات: إحصائيات:يتصفح الموقع الآن 32 شخص، 0 عضو، 32 زائر (انقر هنا لمزيد من التفاصيل عن حركة الزوار)، عدد محتويات الموقع: 2317 |
جميع الحقوق محفوظة لـ الوكالة العربية للصحافة أپاپريس - Apapress .
تغيير السمة: بالاعتماد على برنامج بوابة الجوزاء |
للنشر في الموقع | شروط الإستخدام | للتواصل مع الموقع | نهج الخصوصية | الإدارة | أعلن معنا | فريق العمل | المتعاونون | شعار أبابريس |












.JPG)

.jpg)




