الرئيسية
| شجرة الموقع
| إحصائيات
| قائمة الأعضاء
| سجل الزوار
|إنشاء حساب
| اتصل بنا

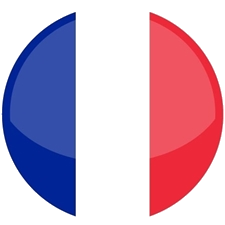

|

|
Loading...
|
جديد الموقع:
|

|
أبواب الموقعقائمة المراسلةحالة الطقسحكمة
الصديق وقت الضيق
تحويل التاريخحدث في مثل هذا اليومصحة جسمكمواقع صديقة |
 الوكالة العربية للصحافة أپاپريس - Apapress الوكالة العربية للصحافة أپاپريس - Apapress
 مقالات مقالات
 كتاب اليوم كتاب اليوم  من يحكي الرواية من يحكي الرواية
 ...جاء تفكيرنا في مقاربة بعض قضايا "السارد" من خلال الاشتغال على نموذج روائي مغربي، يشكل علامة فارقة في التجربة الروائية المغربية والعربية؛ يتعلق الأمر، هنا، برواية "لعبة النسيان" لمحمد برادة، متوخين من خلال ذلك "الإجابة"، ولو نسبيا، عن سؤال مركزي سبق للمنظر الألماني فولفكانك كايزر أن صاغه في مرحلة سابقة، ووضعه عنوانا لدراسته الشهيرة: "من يحكي الرواية؟"(15)، وهو السؤال الذي نستعيره من كايزر لنضعه، نحن أيضا، عنوانا مركزيا لهذا الكتاب، باعتباره سؤالا مؤطرا في عمقه الوظيفي لأسئلة أخرى موازية، من قبيل: "كيف يحكي؟"، "عمن يحكي؟"، "لمن يحكي؟"..، وغيرها من الأسئلة التي يتناسل بعضها من بعض، والتي تحدد للسارد مواقعه "الثيمية"، بحيث يصبح معها السارد بمثابة "ثيمة" أساس في كل سرد. وهو ما يعنى أن فكرة هذا البحث قد تولدت، في البداية، كسؤال- أسئلة نظرية، أصبحت تبحث عن تمظهرها الوظيفي والحكائي والسردي في نصوص روائية عربية.
...جاء تفكيرنا في مقاربة بعض قضايا "السارد" من خلال الاشتغال على نموذج روائي مغربي، يشكل علامة فارقة في التجربة الروائية المغربية والعربية؛ يتعلق الأمر، هنا، برواية "لعبة النسيان" لمحمد برادة، متوخين من خلال ذلك "الإجابة"، ولو نسبيا، عن سؤال مركزي سبق للمنظر الألماني فولفكانك كايزر أن صاغه في مرحلة سابقة، ووضعه عنوانا لدراسته الشهيرة: "من يحكي الرواية؟"(15)، وهو السؤال الذي نستعيره من كايزر لنضعه، نحن أيضا، عنوانا مركزيا لهذا الكتاب، باعتباره سؤالا مؤطرا في عمقه الوظيفي لأسئلة أخرى موازية، من قبيل: "كيف يحكي؟"، "عمن يحكي؟"، "لمن يحكي؟"..، وغيرها من الأسئلة التي يتناسل بعضها من بعض، والتي تحدد للسارد مواقعه "الثيمية"، بحيث يصبح معها السارد بمثابة "ثيمة" أساس في كل سرد. وهو ما يعنى أن فكرة هذا البحث قد تولدت، في البداية، كسؤال- أسئلة نظرية، أصبحت تبحث عن تمظهرها الوظيفي والحكائي والسردي في نصوص روائية عربية.من هنا، تتوخى هذه الدراسة قراءة رواية "لعبة النسيان" لمحمد برادة، من زاوية اشتغال مكون "السارد" فيها بامتياز، باعتبارها نموذجا سرديا ملائما لتشغيل بعض المعطيات والمفاهيم والمقولات النظرية والنقدية الغربية حول السارد، في انتمائها إلى حقل "السرديات" تحديدا، خاصة وأن رواية "لعبة النسيان" جاءت محملة بوعي نظري ونقدي وسردي حداثي لافت، من حيث تشغيلها المركزي والبؤري لمكون السارد فيها، في تعدديته، وفي تنوع مظاهره وأنماطه، وهو ما يضفي على هذه الدراسة، التي أنجزنها في مرحلة زمنية سابقة، وتمت مراجعتها اليوم، خاصية المشروعية والامتداد الزمني، على مستوى المقاربة والاستنتاجات، مادام أنها تساهم في إضاءة بعض زوايا الفضاء الحواري الضروري بين المتن الروائي العربي والمرجعية النظرية السردية الغربية، بما هو متن مازال يستلزم إعادة قراءته وفق مرجعيات ومفاهيم نظرية، لم تفقد بعد كفايتها الإجرائية والتحليلية، وخصوصا في ارتباطها بمكون سردي أساسي، دائم الحضور والتجدد. تعليقات القراء
|
أكثر المقالات تعليقاًأخبارنا بالقسم الفرنسيأخبارنا بالقسم الانجليزيكريم عبدالرحيم التونسي المعروف بعبد الرؤوففوزالباحث المغربي عدنان الرمال بالجائزة الكبرى للابتكار من أجل إفريقيا لسنة 2015الإعلانات الجانبيةصور عشوائيةفيديوهات عشوائيةلعبة |
 إحصائيات: إحصائيات:يتصفح الموقع الآن 40 شخص، 0 عضو، 40 زائر (انقر هنا لمزيد من التفاصيل عن حركة الزوار)، عدد محتويات الموقع: 2317 |
جميع الحقوق محفوظة لـ الوكالة العربية للصحافة أپاپريس - Apapress .
تغيير السمة: بالاعتماد على برنامج بوابة الجوزاء |
للنشر في الموقع | شروط الإستخدام | للتواصل مع الموقع | نهج الخصوصية | الإدارة | أعلن معنا | فريق العمل | المتعاونون | شعار أبابريس |










.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)




